و رداً على توقيعك التافه كتفاهة عقل من رسمه:
سد الذرائع في مسائل العقيدة
د.عبدالله شاكر الجنيدي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فلما كان التوحيد أعظم مطلوب، كانت العناية والاهتمام به من أوجب الواجبات وهذا واضح في دعوات الأنبياء والمرسلين، فما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وجعل لُبَّ رسالته وأساسَ دعوته التوحيد، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يركز ويكرر الدعوة إلي التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة النبوية ونزلت عليه الأحكام والتشريعات كان يبينها ويدعو من خلالها إلى تثبيت وتأكيد التوحيد في النفوس، ليكون الدين كله لله، ولا يعبد أحد سواه، واقتضى ذلك أن يضع القواعد اللازمة لصيانته، وأن يقضي على كل وسيلة مفضية إلى الإخلال به، وأن يسد كل ذريعة يمكن أن تؤدي إلى شائبة فيه، وهذا من كمال الشريعة ومقاصدها الحميدة.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تُفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعًا أن يُقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء"(1).
ولأهمية هذا الموضوع وتجليته؛ وبيان شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد استعنت بالله عز وجل في الكتابة حول هذا الموضوع، وجمع ما تفرق من أقوال لعلماء السلف فيه، وقبل الشروع في المقصود أذكر أولا تعريف الذريعة والأدلة على وجوب سَدِّها.
أولا: تعريف الذريعة
الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده(2).
قال ابن تيمية: "والذريعة: ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم"(3).
وقال الشاطبي: "حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"(4).
والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة(5).
قال ابن تيمية: "واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوصل إليه"(6).
وقال ابن القيم: "وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه"(7).
ثانيًا: الأدلة على وجوب سد الذرائع
دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب سد الذرائع، وإليكم بعض ما جاء من ذلك.
أولا: أدلة القرآن الكريم:
1 قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم{الأنعام:108}.
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي سب المشركين الله عز وجل، فكان النهي سدًّا لهذه الذريعة، وهذا دليل على المنع من الجائز إذا كان يؤدي إلى محرم.
قال القرطبي: "في هذه الآية ضرب من الموادعة، ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع"(8).
ونقل القاسمي عن بعض العلماء قوله في الآية: "إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله، أو رسوله، أو القرآن لم يجز أن يُسَبُّوا ولا دينهم، قال: وهي أصل في قاعدة سد الذرائع"(9).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر"(10).
2 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم {البقرة:104}.
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن كلمة "راعنا"، ومعناها عندهم راعنا سمعك، أي: اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك فيه، وهذا معنى صحيح، ولكن الله نهاهم عنها سدا للذريعة، لأن اليهود كانوا يقولونها لاوين بها ألسنتهم، لتوافق كلمة شتم عندهم، أو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة.
وسيأتي كلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى فيما بعد.
ثانيًا: الأدلة من السنة:
1 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"(11).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل لاعنا لأبويه إذا كان سببا في ذلك، وإن لم يقصده.
قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث "فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقًا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين.......، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك. والله أعلم"(12).
وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث: قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله(13).
2 قال عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق: "أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"(14).
ووجه الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، لئلا يكون ذريعة لتنفير الناس عنه وقولهم: إن محمدا يقتل أصحابه.
يقول ابن تيمية في ذلك: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه، وممن لم يدخل فيه، وتنفيرهم هكذا حرام"(15).
ثالثًا: الإجماع:
أجمع الصحابة على بعض المسائل التي يمكن أن يستدل بها على وجوب سد الذرائع، وقد اعتبرها أهل العلم أدلة على سد الذرائع واحتجوا بها، كما عمل بها كثير من الأئمة، وإليكم بعض الأدلة.
1 إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف(16).
وقد رجح ابن قدامة توريثها فقال: "وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته، ولم يرثها إن ماتت...، وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير لا ترث مبتوتة....، ولنا: أن عثمان رضي الله عنه وَرَّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا"(17).
2 إجماع الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، قال ابن قدامة: "... ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر"(18).
وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع، وحكَّمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه، كما ذكر الشاطبي(19)، وقال بعد أن ذكر خلافا بين الإمامين مالك والشافعي: "فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة"(20).
وقال ابن بدران: "سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا"(21)، يعني الحنابلة.
وقد قال بها ابن تيمية، وذكر لها ثلاثين شاهدا من الشريعة يدل عليها(22)، وتوسع ابن القيم فذكر تسعة وتسعين دليلا عليها، وختم كلامه بقوله: "ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة...، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين"(23).
مجلة التوحيد 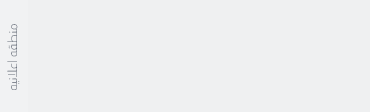

 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


October 29th, 2009, 09:05 AM
أوضح الدكتور عماد بن يحيى يرد الحسني أستاذ مقارنة الأديان والمحكم الدولي المعتمد أن كلمة الاختلاط «تشكلت في أذهان الناس مؤخراً، وأنها غير متعارفة فيما يتعلق بالمرأة والاحتشام والمحافظة على المحارم إلا لدى المتأخرين»، مبينا أن «علماء الإسلام قبل عدة سنوات وكذلك عامة الناس لا يعرفونها، بل على العكس من ذلك نجدهم يعرفون جيداً كلمة «الخلوة»، و«التبرج»، و«الستر».وزاد الحسني أن كلمة الاختلاط «دخلت فيما يتعلق بالمرأة على كتب الثقافة الإسلامية التي تتوسع في استخدام الكلمات والعبارات نقلا عن غيرها مثل كلمة الخلاص والمخلص وغيرها»، لافتا إلى أنه اطلع على بعض النتائج في كتب فقهاء المسلمين المتعلقة باستعمالها، واستنتج أنها «تتحدث عن معاني أخرى، وإذا استخدمت للمرأة فتعني الاختلاء بها أو الذهاب لمجمع الرجال الذي ليس فيه نساء ونحو ذلك، وهي قليلة غير مقصودة كعبارة مصطلحية، بينما بالمفهوم المنتشر حالياً في كتابات المثقفين الإسلاميين لا يستخدمها الفقهاء السابقون».
وهنا يشير الحسني إلى أنه «حصر الكثير من النتائج عن طريق البحث في المكتبة الفقهية الإلكترونية، ولم تشكل كلمة الاختلاط أي معنى مصطلحي في أجندة مصطلحات الفقه، بينما على صعيد التركيب المشاكل نجدها في كتب: «الجرح والتعديل» عند علماء الحديث الشريف، عندما يتحدثون عن الشخص غير الثقة في حديثه ليس بسبب تدينه أو أمانته، إنما لخلل في شرط ضبط الحافظة لديه لأسباب مرضية أو لأسباب أخرى، وأنه بسبب ذلك يقال اختلط في آخر عمره، أو لديه «اختلاط»، ويعرفون الاختلاط ويقسمونه ومتى يقبل حديث هذا النوع ومتى لا يقبل الخ...».
ويثبت الباحث الحسني عبر الدراسات المسحية في علم الأديان أن كلمة الاختلاط فيما يتعلق بالمرأة والرجل، «موجودة ضمن بعض معاجم المصطلحات اللاهوتية، وأنه بالجرد التاريخي وجد أنها تسللت إلى اللغة التركية وتبناها في القرن الماضي بعض المثقفين الأتراك، وألفوا فيها بعض المؤلفات بعد أن توسعت حركة التأليف والكتابة من قبل العلماء والمثقفين الأتراك، وأن الاستخدام الاصطلاحي لها عندهم، يطابق الترجمة الاصطلاحية اللاهوتية، ما يعني ـ والحديث للحسني ـ إمكانية تسللها إلى الثقافة التركية من خلال هذا المنفذ، حيث التقت الثقافة التركية مع العديد من الثقافات الأوربية بعد انتشار التوسع العثماني في أوربا وأصبح هناك كلمات متداولة بين الثقافتين».
ويؤكد الباحث أن «الاختلاط في القاموس الكنسي كان بخصوص منع بعض الكنائس للراهبات من الاختلاط مطلقاً بالرهبان على أساس عدم تحريك الوازع الغريزي بترك الرهبنة ومن ثم التفكير بالزواج، ومنهم من يتميز بمرور سنين طويلة على ذلك، وتعتبر في مقاييس الكنيسة درجة عالية في الرهبنة، وهذا حسب البحث يمثل اتجاها كنسيا سابقا، فيما الكثير من الكنائس الحديثة على عكسه».
وهنا يشير الباحث الحسني إلى أن «بعض المعلقين على المعاجم الكنسية يذكرون ورود المصطلح في إنجيل لوقا دون الإشارة إليه، لكنه غير صحيح في الحقيقة، ما يعني أنه اجتهاد ناشئ في مفاهيم الرهبنة، ومن المحتمل أن يكون استعمل في الإنجيل بلفظة قريبة وتطورت دلالتها ليركب منها مصطلح كنسي وفق مفاهيم لاهوتية تتعلق بتكريس مفهوم الرهبنة». ويشدد الحسني أستاذ مقارنة الأديان والمحكم الدولي المعتمد على أن الأساس اللغوي للكلمة «يعني أكثر مما تقصده الكنيسة، حيث يعني المعاشرة»، مستندا إلى حقيقة أن «خلط الشيء يعني جمعه ليكون مختلطاً مع بعض باحتكاك وتمازج، ولا يعني مجرد الصورة التي يشاهد فيها النساء والرجال»، مؤكدا أن هذا «ما لوحظ على المصطلح الكنسي، حيث استخدمها في مجرد التقابل بينما هي في جذورها في الترجمات تعني أوسع من ذلك».