September 21st, 2007, 09:37 PM
أعلم أن مكتب الدكتور عبدالله العثمان، مدير جامعة الملك سعود المعين حديثاً، لا يكاد يتسع لورقة إضافية، ولا لتقرير جديد، أو مقال مكرور، فالكتابة حول التعليم العالي في السعودية مؤخراً أكلت من أوراق الصحف، وأذهان المسؤولين، ما أكلت، وقُرع الجرس مرات عديدة حتى لم يعد ثمة حجة لسامع، ولا مزيد لمنتقد، إلا إن كان من هواة ضرب الموتى. ونتيجة لهذه الاحتفالية النقدية القاسية التي تعرض لها مسؤولو التعليم العالي، أعتقد أن شيئاً ما يثمر ببطء، وينضج على مهل، فردود الأفعال حتى الآن تبدو مبشرة، وبوادر التغيير واضحة وجادة، وتصريحات المسؤولين أخذت طابعاً أكثر عملية، وصراحة، وشفافية مما كانت عليه من قبل، وهذه هي عادتنا في اليقظة المتأخرة، عندما (نشارف) الأزمة، ولا (نستشرفها)، فلا جديد هنا. وجامعة الملك سعود ليست بمعزل عن هذا التغيير، بل هي في قلبه تماماً، بصفتها أكبر جامعة في السعودية، وأعتقد أن من يتابع تصريحات الدكتور عبدالله، ونشاطه الإعلامي والإداري منذ توليه هذا المنصب المعقد، في هذا التوقيت الحرج، يعرف أن التغيير القادم يحمل طابعاً ثورياً، واللغة القادمة هي لغة عمل، ونتائج، ومحاسبة، وليست لغة التطمينات الخطابية المعدة للاستهلاك اليومي. فلعل وعسى، ونحن في الانتظار.
أعود إلى مكتب معاليه، والأوراق المكدسة عليه، من تقارير، وخطط، واستراتيجيات، وتوصيات، وغيرها، لا بد أن ما فيها دقيق، وبنّاء، وجاد، إلا أني أعتقد أن من الأوراق المفيدة، وأكثرها استحقاقاً للمكث مدة أطول فوق مكتب الدكتور عبدالله، وبين يديه، ونصب قراراته، هي يوميات الطالب الجامعي، بحكم أن الطالب (كما يُفترض) أساس العملية برمتها، وبما أن هذا النوع من التقارير (الفنتازية) غير موجود، فهذه إذن محاولة لاستقراء كل ذلك، ودمجه في مقال مختصر (مختصر قدر المستطاع، وفق ما تسمح به نظرية الشق والرقعة الشهيرة)، وهو يصف الحالة العامة لطالب في جامعة الملك سعود، بدأ مستجداً، وانتهى وهو مستجد، لأن المعضلة الجامعية كانت أكبر من فهمه، والمتاهة الأكاديمية التي حط بها أخيراً أفقدته الصواب والخطأ معاً، فانتهى أخيراً إلى ما انتهى إليه غيره، وسلم زمام أمره لممرات الجامعة، تسيره كما تشاء أمزجة الأكاديميين الكبار، فمنذ بداية دخوله الجامعة يشعر الطالب أن للممرات عليه سلطة ما، وعليه أن يحترمها وهو يطأ عليها ما دامت خطاه ستعقد صداقةً معها لأعوام مديدة، سواءً وهو (يسافر) من قاعة إلى قاعة ليلحق بمحاضرة، أو (ينغرز) مثل وتد منسي أمام مكتب دكتور لا يعترف بساعاته المكتبية، أو يصطف في صفوف المنقطعين والغارمين لاستلام مكافأة، أو تسجيل مادة، أو شراء وجبة! ورغم ذلك، تظل علاقته بالممرات أجمل بكثير من غيرها، فممرات جامعة الملك سعود، على الأقل، أقل تعقيداً من قوانينها، لاسيما تلك غير المكتوبة، والتي يطلقها في الهواء كل دكتور أو محاضر أو معيد حسب مزاجه اليومي أو الفصلي أو السنوي أو الأبدي! ويستقبلها الطلاب مثلما يستقبل الراديو موجات الإرسال، فيمتثل لها كما هي، دون أن يكون له الخيرة في تغيير حرف منها، مما يعمق لديهم الشعور التدريجي (الذي يتحول عند التخرج إلى مسلّمة!) بأنهم إنما انتقلوا من مدرسة أصغر، إلى مدرسة أكبر، مع الاحتفاظ بميزة الرعاية والاهتمام الشخصيين للمدرسة الأصغر طبعاً، مقارنة بهذه الغابة الأكاديمية. هذا الطالب تعرف أثناء حياته الجامعية الدرامية على المسجل (أ) والدكتور (ب) والمحاضر (ج)، والمعيد (د). وهو بحاجة أن يسرد قصصهم جميعاً، فكلهم ساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل الخارطة النفسية للطالب، وغير مسارات حياته الجامعية، وعكس توقعاته، وخربش على جدار أحلامه، وعلمه كيف تؤخذ الدنيا (غلابا)!
وحالما يُقبل الطالب في الجامعة، ويبدأ يومه الأول، يستلم جدول المواد المفروضة عليه فرضاً، مثلما يستلم الجندي ملابسه وبسطاره، دون أن يختار منها مادة واحدة، وهذا التسجيل الإجباري هو ميزة أكاديمية تنفرد بها جامعة الملك سعود دون كل جامعات العالم (ما عدا الجامعات المتميزة أيضاً هي الأخرى) فلله درها، ويبرر المسؤولون ذلك بأنه عند تطبيق النظام السابق، التسجيل الاختياري، أدى انخفاض وعي الطلاب إلى تأخر تخرجهم بشكل فاضح، وبالطبع فإن الطالب هو المسؤول عن كل مشاكل الجامعة، وهو العنصر السيئ الذي ينبغي استئصاله من الجامعة حتى يصلح حالها، ويعتدل أمرها. فبما أن كل طلاب الجامعة لا يحملون وعياً كافياً بالتسجيل الاختياري، قررت إدارة الجامعة حرمانهم منه حرماناً جماعياً، وعن بكرة أبيهم، تخفيفاً للصداع الإداري الذي تسببه إجراءات التسجيل، والتكدس الطلابي الذي يسببه تأخر التخرج، وهذا قمة العدل، لأن أعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي الجامعة بريئون تماماً من بيرواقراطية إجراءات التسجيل، وتأخر التخرج، وكل المشاكل من هذا الطالب، قليل الوعي!
ورغم ذلك، يسعى الطالب المستجد أن يجرب حظه للمرة الأولى، ويحاول مثلاً، يحاول، أن يغير إحدى المواد، فيذهب إلى مسجل الكلية الذي ينتمي لدولة عربية مجاورة، ولا يدري أية كفاءة هائلة يتطلبها هذا المنصب حتى إنه لا يوجد سعودي يشغله! فيفاجأ بكومة من الطلاب أمام المكتب الصغير، يتدافعون بشكل يكاد يخيفه، ويدفعه للعودة من حيث أتى، إلا أنه يشد من عزيمته، ويردد في نفسه (هذا هو التحدي الأكاديمي الأول لي!)، فيتدافع مع المتدافعين، ويتزاحم مع المتزاحمين، حتى إذا وصل أخيراً إلى حافة مكتب المسجل، لاهثاً متعباً، وقدم له جدوله الذي تكرمش من شدة التدافع، وطلب تغيير المادة بكل أدب، صاح في وجهه المسجّل العربي ((لا، ممنوع، امش من هنا!))، فيجيبه بانكسار ((ولكني لا أرغب بدراسة هذه المادة في هذا الفصل؟))، فيرد عليه المسجل بصوت أعلى ((مش على كيفك! النزام كده!))، فيقرر أن يترك المكتب، يائساً، ومرتبكاً، ولكنه أثناء خروجه، يتناهي إلى سمعه المسجل وهو يتحدث في الهاتف عن طالب آخر: ((الطالب ده لازم نسجل له المادة دي، دا ابن عميد كلية ال.....!)).
هذا هو المسجل (أ)، النزيه جداً، النظامي المحترف، ذو الكفاءة المهنية التي عجز عن إنجاب مثلها كل هذا الوطن، بمعدل بطالته الذي وصل إلى تسعة بالمئة من ذكور الشعب، فضلاً عن إناثهم، والذي، من فرط ثقته بنفسه و(ظهره)، ومهنيته العالية، لا يتورع أن يصدع بكلمة (الواسطة) تلك، في حضرة عشرات الطلاب الواقفين أمامه، وهو المناطة به أمور تسجيلهم ودراستهم، فإذا به يمنح نفسه حق العطاء والمنع، والتفضل والحرمان، بل و(تسعود) جداً حتى أصبح يمارس (الواسطة) علناً، على طريقة مواطنه التاريخي فرعون عندما سألوه: من فرعنك؟ فأجاب إجابته الشهيرة. هذا المسجل اللطيف سيظل يتعامل مع صاحبنا الطالب في بداية كل فصل دراسي طيلة السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وهو ينفرد بفضل أنه قدم للطالب المستجد أول خيباته الجامعية في هذا (الحرم) الجامعي الذي يُفترض ألا تنتهك فيه الأخلاق، ولا ينكسر فيه النظام.
وهكذا يطوي الطالب جدوله، ويقنع نفسه أن واضعي الجدول هم أدرى بمصلحته، ولعلهم يرون ما لا يراه، والله المستعان. حتى إذا ولج القاعة، راح ينتظر بترقب كبير أن يرى ذلك الكائن الأسطوري المنتظر (الدكتور)، مستحضراً في ذاكرته الشعبية كل الحكايات التي سمعها من أخيه الأكبر، أو صديقه في الاستراحة، أو جاره الذي يمشي معه إلى المسجد، أو غيرهم، عن (دكاترة) الجامعة، وكيف أنهم (بشرٌ) غير أولئك المدرسين الذين تعود عليهم في الثانوية، فهؤلاء لا سلطة لمدير عليهم، ولا يخيفهم المرشد الطلابي، ولا ولي أمر الطالب، فإذا قضوا أمراً فلا رادّ له إلا قضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا حكموا على طالب ما بالرسوب، فلا ينقض حكمهم لا استئناف، ولا رئيس القسم، ولا ديوان المظالم، ولا النظام القضائي بأسره، وإذا عنّ لطالب أن يشتكي فلقد حكم على نفسه بالموت الأكاديمي في بركة البيروقراطية الموحلة التي لا تستنكف أن تحيل الخصم، حكماً، في وجه الطالب المسكين!
أثناء انتظار الطالب للدكتور في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود، يتذكر تلك الأسطورة القديمة والشهيرة التي سمعها من أخيه الأكبر الذي تخرج من نفس الجامعة قبل عدة سنوات، عن ذلك الدكتور الذي قال لطلابه في أول محاضرة ((ممتاز ما يقدر عليها إلا الله، والجيد جداً ما يقدر عليها إلا أنا، والجيد ياخذها الشاطر منكم، والبقية كلهم مقبول أو رسوب!))، ولا يدري الطلاب إلى أي نظرية تحفيزية تنتمي هذه العبارة الأوتوقراطية في علوم التربية والأكاديميا؟ ولكنها تظل أسطورة شهيرة على أي حال، وربما لا تكون واقعية، هكذا يحاول الطالب أن يشجع نفسه، رغم أنه بمرور الفصول الدراسية، يكتشف فعلاً أن درجة (الممتاز) صعبة المنال، ولا ينالها إلا أقل من 10% من الشعبة بأسرها، فيندهش، لأن زميله الذي تخرج معه من الثانوية بمعدل أقل من معدله، وسافر إلى أمريكا ليدرس في جامعة أفضل في التصنيف العالمي من جامعة الملك سعود، (بل وتبتعث جامعة الملك سعود طلابها لتحصيل الدكتوراه منها)، يتصل معه عبر الإنترنت يومياً، وهو يحصل على (الممتاز) في أغلب مواده حتى الآن، وبما أنهما يدرسان نفس التخصص، فإنه من الغريب أن تكون (الممتاز) الأمريكية سهلة المنال نسبياً، ويحصل عليها أكثر من 50% من الطلاب، بينما (الممتاز) السعودية عزيزة، متمنعة، صعبة المنال، ولها (خصوصية) تتيح لها أن تكون كذلك!
يقلب الطالب في عقله المرتبك كل هذه الأفكار المتناقضة، وهو يطالع سجله الأكاديمي المتهالك، بعد أن صارت الـ 95% التي أحرزها في الثانوية شيئاً من النوستالجيا المؤلمة! ترى لماذا يصعب عليّ أن أحصل على الممتاز في جامعة الملك سعود، بينما صديقي الذي كان أقل مني مستوى، يحرزها بسهولة في أمريكا، وفي جامعة متفوقة في التصنيف الأكاديمي على جامعة الملك سعود؟ علماً بأنه، حسبما يحكيه لي عبر الإنترنت، لا يكاد يدرس! لماذا (الدكاترة) في السعودية يصرون على أن يجعلوا الأخ (مقبول) الحليف الجامعي الحتمي لأغلب الطلاب؟ رغم أن هؤلاء الدكاترة أنفسهم، تخرجوا من أمريكا، وشديدو الاعتداد بشهاداتهم الأمريكية الأنيقة، فما الذي يمنعهم أن (يقتدوا) بدكاترتهم الأمريكان السابقين في منح (الممتاز) بسهولة يا ترى؟
ثمة لغز هنا! وهو لا يشغله وحده، بل يشغل الآلاف من الطلاب المصابين بلعنة (المقبول) و (الجيد)، فيطلقون أسئلتهم في كل الاتجاهات الممكنة، مثلاً باتجاه: دكتور متعاون، يجيب على أسئلة الطلاب بنزاهة، أو رئيس قسم سابق، قرر أن يكشف المستور. والإجابة الشائعة التي لم يؤكدها أحدٌ بعد، أن نسبة النجاح في كل شعبة يتم تحديدها سلفاً، ولأسباب غير معروفة، ولكن الإشاعات تقول إن مرد ذلك هو منع تكدس الطلاب في المواد المتقدمة، أو تقنين نسبة الخريجين لتتوافق مع قدرة سوق العمل على الاستيعاب! وهذه الأخيرة لا بد أنها توجيهات عليا، لا يمكن خرقها، مهما كان الضمير الأكاديمي لدى الدكتور يقظاً، ومتمرداً، فثمة رئيس قسم، وكيل كلية، أو عميد ما سيراجع درجات الطلاب قبل اعتمادها. وبغض النظر عن صحة التبريرات، والتعليلات، والإشاعات، فالمشكلة قائمة، وغريبة فعلاً، أن يكون أغلب خريجي الجامعة الأكبر في السعودية من أصحاب المقبول والجيد، لابد أن السبب أيضاً هو (قلة وعي) الطلاب!
نعود لصاحبنا الطالب، بعد أن مرت عليه ثلاث سنوات من الدراسة في الجامعة، جاء اليوم الذي صدقت فيه الأسطورة الشهيرة. كان الطالب يجلس في منتصف مدرج هائل في كليته، يغص بمئة وعشرين طالباً، ورغم أن المادة ليست من المتطلبات الأساسية في الكلية، إلا أنها مزدحمة بالطلاب من فرط الرسوب، والتراكم، ثم الرسوب، فالتراكم. ولا يدرّسها إلا دكتور واحد، من الإخوة العرب الذين تتفوق فرنسيتهم على عربيتهم بكثير، وهو (يحتكر) تدريس المادة، كما يحتكر اللوفر لوحة الموناليزا، مع الفارق الجمالي الواسع. هذا هو الدكتور (ب)، الذي دخل دخول الفاتحين، وجلس على الكرسي، وراح يتأمل المدرج الهائل المليء بضحاياه السابقين، وضحاياه اللاحقين، وبعد صمت ثقيل استمر لخمس دقائق، لا يكاد فيه الطلاب ينبسون ببنت شفة، تكلم الدكتور بصوت هادئ: ((أنا، لمن لا يعرف اسمي منكم، اسمي (...)، وهذه المادة هي (...)، والممتاز لا يقدر عليه إلا الله، والجيد جداً لي أنا، وباقي الدرجات لكم!))
يا إلهي! الأسطورة تتحقق! وفي المدرج الكبير، سرت رعدة جماعية شملت جميع الطلاب، وراح كل منهم يفكر في شكل سجله الأكاديمي بعد هذه المادة، وهو مثقوب بالرسوب، أو المقبول، بتوقيع هذا الدكتور. ولوهلة، فكر صاحبنا الطالب أنه أخيراً فهم سبب التشابه اللفظي بين (الدكتور) و(الدكتاتور)، وكم للّغة من أسرار! ولكنه احتفظ باكتشافه الشخصي لنفسه، بينما ساد الوجوم في الوجوه والعيون، وسرت همهمات غير بريئة، في الصفوف الخلفية. كان المشهد في المدرج محزناً، إلا أنه يصلح ليكون أبلغ رد على كل من يتهم السعودية باضطهاد الجاليات العربية، أو التقليل من شأنها، فليأتِ لينظر ما يفعله هذا الدكتور العربي الرائع، في أكثر من مئة وأربعين طالباً سعودياً، كلهم يؤمن بالله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره!
منذ بداية المادة، عرف صاحبنا الطالب الذي صار خبيراً في موازين القوى الأكاديمية بعد ثلاث سنوات في الكلية، أن هذا الدكتور لا قبل له بمواجهته، وأن فرصته الوحيدة للنجاة من هذه المادة التي يحتكرها الدكتور منذ أبد الآبدين هو الدعاء بأن ينجح فيها بهفوة إحصائية من علم الاحتمالات. وهرع فور فراغ المحاضرة الأولى ليبحث عن مدرس خصوصي من بين المعيدين والمحاضرين الموجودين في القسم، وبالطبع، لزيادة فرصه في النجاح، يجب أن يكون هذا (المحاضِر) الخصوصي من نفس جنسية الدكتور، وهذا ما فعله، وبالتالي تعرف أخيراً على المحاضر (ج)، والذي تفاوض معه على تسعيرة الدروس الخصوصية الثابتة في السوق السوداء للكلية وهي خمسة آلاف ريال للطالب وحده، وسبعة آلاف للطالبين، وتسعة آلاف لثلاثة طلاب، واختار صاحبنا أن يدرس وحده، لعل ذلك يجعل شفاعة المحاضر عند الدكتور أسهل، واستدان الآلاف الخمسة من بعض أقاربه، واعداً إياهم أن يردها لهم بعد التخرج!
بدأت الدروس الخصوصية، وبدأ هذا الطالب في الاستذكار بشكل استثنائي، حارصاً ألا تفوته شاردة ولا واردة ينطق بها الدكتور في المحاضرة إلا سجلها في مذكرته بأربعة ألوان، وحارصاً بشكل أكبر على إكرام المحاضر الذي يأتيه في البيت أيما إكرام، فلا يكاد المحاضر (يقلط) حتى تكون القهوة والشاي والمعجنات في انتظاره، وربما تأخر عليه قليلاً فاستغل الفرصة ليطلب منه البقاء للعشاء، لعله يتذكره في يوم الشفاعات، رغم أن المحاضر كان واضحاً معه من أول درس بأنه لا يملك للطلاب نجاحاً ولا رسوباً، وأن الدكتور (ب) صارم جداً في تصحيحه، وملتزمٌ جداً بنسبة النجاح التي يحددها له رئيس القسم، إلى حد أنه عندما يبدأ في تصحيح أوراق الطلاب المئة والعشرين، واحدة تلو الأخرى، ثم يجد في منتصف تصحيحه أن الناجحين منهم وصلوا للنسبة المحددة، أخذ بقية الأوراق غير المصححة، دون أن ينظر إليها، وسجلها رسوباً. فضحك الطالب من نكتة المحاضر هذه، واعتبرها من (لهو الحديث)، ورفض تصديقها، بينما زمّ المحاضر شفتيه، وهزّ رأسه باستخفاف، وراح يكمل الشرح.
نجح الطالب في المادة، وتحققت الشفاعة. وكانت درجة (الجيد) التي أحرزها تستحق الاحتفال بعد أن تجاوزت نسبة الرسوب في الشعبة الأربعين في المئة، كما يثبت ذلك الأرشيف السري للقسم بالطبع، وكانت درجات الطلاب تعكس دقة عبارة الدكتور التي بدأ بها الفصل، ومصداقاً لما أسماه بإنجليزيته ذات اللكنة الفرنسية (integrity).
المعيد (د) هو طالب حديث التخرج، يمارس الإعادة في القسم في انتظار إجراءات ابتعاثه، وعندما ولج صاحبنا الطالب إلى محاضراته كان مستبشراً بأنه مقبل على التعامل مع طالب مثله، يشعر بما يشعر به، ويقتسم معه الهموم والظنون. ولكن يبدو أن سلسلة التوقعات الخائبة منذ التحاقه بالجامعة ما زالت مستمرة، فهذا المعيد الشاب لم يكن إلا (ابن الحجاج)، ولقد بدأ محاضرته بطريقة عجائبية في فرد عضلاته الأكاديمية، هو الذي تفصله أشهر قليلة فقط بين هذا الكرسي، وتلك السبورة. فبعد مقدمة بسيطة، راح يتلو على الطلاب قوانينه الشخصية. وكان أولها: ((يمنع منعاً باتاً على الطلاب أثناء المحاضرة.. الإمساك بالقلم!))، ولم يفهم الطلاب ما هو العائد التعليمي من هذا القانون، فاستزادوه توضيحاً وهم ما يزالون يعتقدون أنه مقرب منهم بصفته حديث التخرج، فقال لهم: ((هذا هو نظام محاضرتي، اعتبروا أنكم في خطبة جمعة، ومن مسّ الحصى فقد لغى!))
يحرم المعيد (د) على الطلاب نقل ما يكتبه على السبورة من الشرح إلى دفاترهم، ولا حتى تدوين الملاحظات العابرة، ولاشك أن هذه ثورة في نظم التعليم الحديث، لم يسمع بها الطلاب من قبل. ولما كان القانون عجائبياً فعلاً، قام بعضهم بمخالفته من باب (الحرية الشخصية)، ومنهم صاحبنا الطالب الذي أخرج قلمه، وراح يدون ملاحظاته على الشرح في دفتره الشخصي، ففوجئ بالمعيد يشق صفوف الطلاب فجأة، ويتجه إليه مباشرة، ويأخذ دفتره، وينتزع الصفحة التي كتبها الطالب، ويرميها في سلة المهملات!
وبغض النظر عن كل الممارسات التعسفية التي يمكن أن ترتكب بحق أي طالب مغلوب على أمره في جامعة الملك سعود، فإن أغلبها لا يتجاوز السلطات الأكاديمية والإدارية، بينما ما فعله هذا المعيد (د)، كان اعتداءً شخصياً على الطالب، وتخريباً متعمداً لممتلكاته الشخصية، وإهانة مباشرة لكرامته. و هذا ما دفع صاحبنا الطالب لحمل أوراقه، والخروج من القاعة، حانقاً، وغاضباً، وهو يشعر بمرارة الإهانة، وأن سنوات عمره الاثنتين والعشرين لم تمنع من أن يتعامل معه من يكبره بسنوات قليلة بهذا الأسلوب المهين. بينما ساد الوجوم في القاعة التي تغصُّ بالطلاب الثلاثين، لم يكسره إلا صوت الباب الذي انغلق بعد خروج صاحبنا، بينما راح طلاب آخرون يعيدون دفاترهم إلى حقائبهم بهدوء.
ابتلع الطالب تلك الإهانة مقنعاً نفسه أنه لم يبق إلا سنة على التخرج، ولا داعي لخلق المشاكل، لا سيما تلك المشاكل التي لا طائل منها، فليس من المتوقع أن يؤنب رئيس القسم أو عميد الكلية معيداً متفوقاً، ودكتوراً محتملاً، من أجل طالب، ولو كان ذلك متوقعاً وممكناً لانعكس على سلوك المعيد أصلاً. واستمع الطالب إلى نصيحة أخيه الأكبر الذي تخرج في الجامعة قبله ((كلما كنت مجهولاً ومغموراً، تيسرت أمورك، وتخرجت سريعاً!))، وعاد صاحبنا الطالب إلى محاضرة المعيد، مكتفياً بالسواك هذه المرة بدلاً من القلم، ومعتمداً على ذاكرته فقط في تذكر كل الملاحظات التي يمكن أن يستنبطها من الشرح.
الغريب المريب، والذي يثبت فعلياً أن لكل عضو هيئة تدريس (دستوره) الشخصي في تسيير المادة، أنه في مادة أخرى، كان المعيد من جنسية عربية ينتقد أحد الطلاب لأنه لا يقوم بتدوين الملاحظات، وصدح بقانونه المسجوع ((كل علم لم يحفظ في القرطاس ضاع، وكل سر تجاوز اثنين شاع!)). ومن الطبيعي أن يكون لكل عضو هيئة تدريس قوانين صغيرة يسيّر بها محاضرته، ويعتمد عليها أسلوبه في التعليم، ولكن بعض القوانين تتضخم بشكل سرطاني، وتتحول إلى أحكام قطعية، تعسفية، ومشخصنة جداً، تفقد معها مردودها التعليمي المرجو (إذا افترضنا أن لها مردوداً إيجابياً أصلاً)، وتتحول في النهاية إلى مجرد أساليب سلوكية تهدف إلى بناء هرم من الهيبة الوهمية، تيسّر على الدكتور عمله، وتجعله أكثر رضا عن نفسه.
تخرج الطالب في الجامعة، وبحث عن وظيفة فور تخرجه، لعل أجواء العمل تعيد تأهيله نفسياً، وتركيب شخصيته المبعثرة، بعد تجربته الجامعية المريرة، والتقى بزميله في الثانوية الذي تخرج من أمريكا في نفس التخصص، (وبالطبع حصل على وظيفة قبله بأشهر طويلة!)، وراحا يتسامران ويتذكران أيام الثانوي المشتركة، ثم أيام الجامعة المختلفة. وقتها لم يفهم صاحبنا الطالب أبداً معنى أن يقول له زميله ((ياااه.. فعلاً.. سنوات الجامعة هي أجمل السنوات في عمر الإنسان!))، هل حقاً أن زميله جاد فيما يقول، أو أنه يهذي فقط؟ هل من المعقول أن (أجمل سنوات العمر) قد فاتته دون أن ينتبه لها؟ هل يعقل أن تكون أجمل سنوات عمره هي تلك التي قضاها في جامعة الملك سعود؟
معالي الدكتور عبدالله العثمان:
ما زال المسجل (أ)، والدكتور (ب)، والمحاضر (ج)، والمعيد (د)، ونماذج أخرى شبيهة، يعملون في جامعة الملك سعود بنفس الوتيرة، متسببين معاً في تشويه التجربة الجامعية للآلاف من الطلاب، وإلحاق الضرر النفسي والأكاديمي بعماد الوطن، فضلاً عن (تفويت) أجمل سنوات العمر! هذا الاتهام المباشر ليس عاطفياً أو درامياً كما يبدو، بل هو اتهام شرعي لا يطالب بأكثر من الحقوق الأساسية لصاحبنا الطالب، حسب تجربته الجامعية، وربما إن تجارب طلاب آخرين تفترض مطالب أخرى، (ودعنا لا نتكلم عن الطالبات حتى لا ينفرط المقال إلى عدة صفحات أخرى!)، ولكن صاحبنا يكتفي بالمطالبة بأشياء تبدو بدهية، مثل العدالة الإدراية في التسجيل، وإنشاء نظام محكم يضمن تطبيق النظام على الجميع، وهذا يبدو اقتراحاً حالماً في الجامعة التي ما زالت تكافح من أجل عدالة (القبول) فضلاً عن عدالة (التسجيل)، فلو تمكنّا، جدلاً، من الوصول إلى جهاز الحاسب المركزي، وطلبنا تقريراً عن طلاب الجامعة الذين تخرجوا في السنوات العشرين الماضية، مع معدلات الثانوي لكل منهم، لرأينا أرقاماً عجيبة! ليس لها أية علاقة بمتطلبات القبول في الجامعة! ولكن نسأل الله أن تبقى هذه المعلومات حبيسة الأرشيف حفاظاً على ماء وجه مسؤولي القبول، فصاحبنا لا يطالب بهذه الأشياء المستحيلة عموماً لفرط واقعيته، بل يطالب بالممكن المعقول وما يتم تطبيقه فعلياً في كل جامعات الأرض، مثل أن تتاح للطلاب حرية اختيار المواد التي تناسب استعدادهم الذهني للدراسة في هذا الفصل أو ذاك. ويطالب أيضاً بالعدالة الأكاديمية في التقييم والدرجات، وإنشاء نظام أكثر مرونة يكفل للطالب حق الاعتراض على تقييم الدكتور له، بل وتقييم الطالب للدكتور نفسه تقييماً يؤخذ في الاعتبار بجدية عند اتخاذ قرارات ترقية الدكاترة، وعلاواتهم، ومن المعروف أن هذا صعب، لكون الجامعة جهازاً حكومياً، يرضخ لاعتبارات بيروقراطية معقدة، وكون أعضاء هيئة التدريس موظفين حكوميين، مما يجعل التدخل في آلية ترقياتهم وعلاواتهم ليس بالأمر السهل، ولكنها ضرورة ملحة في النهاية، وإحداث التوازن القانوني بين الطالب والدكتور هو المفتاح الأساس لعلاقة أكاديمية إيجابية.
ربما راح المقال يخرج عن مساره المفترض، ليتحول إلى سلسلة مطالب لا أتوقع أن مكتب الدكتور عبدالله العثمان ينقصه المزيد منها، وعلى أي حال، الثقة موجودة في أن القادم سيكون أفضل، والتغيير المرتقب قريب. المطالب كثيرة يا دكتور عبدالله العثمان، والمسؤولية التي بين يديك ليست سهلة. والوطن يراقب، و(الوطن) أيضاً.
المصدر
جريدة الوطن السعودية، 19 يوليو 2007 جريدة الوطن السعودية، 26 يوليو 2007 جريدة الوطن السعودية، 2 أغسطس 2007 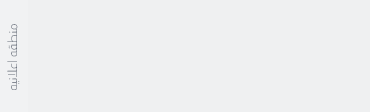

 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks


September 21st, 2007, 09:37 PM
أعلم أن مكتب الدكتور عبدالله العثمان، مدير جامعة الملك سعود المعين حديثاً، لا يكاد يتسع لورقة إضافية، ولا لتقرير جديد، أو مقال مكرور، فالكتابة حول التعليم العالي في السعودية مؤخراً أكلت من أوراق الصحف، وأذهان المسؤولين، ما أكلت، وقُرع الجرس مرات عديدة حتى لم يعد ثمة حجة لسامع، ولا مزيد لمنتقد، إلا إن كان من هواة ضرب الموتى. ونتيجة لهذه الاحتفالية النقدية القاسية التي تعرض لها مسؤولو التعليم العالي، أعتقد أن شيئاً ما يثمر ببطء، وينضج على مهل، فردود الأفعال حتى الآن تبدو مبشرة، وبوادر التغيير واضحة وجادة، وتصريحات المسؤولين أخذت طابعاً أكثر عملية، وصراحة، وشفافية مما كانت عليه من قبل، وهذه هي عادتنا في اليقظة المتأخرة، عندما (نشارف) الأزمة، ولا (نستشرفها)، فلا جديد هنا. وجامعة الملك سعود ليست بمعزل عن هذا التغيير، بل هي في قلبه تماماً، بصفتها أكبر جامعة في السعودية، وأعتقد أن من يتابع تصريحات الدكتور عبدالله، ونشاطه الإعلامي والإداري منذ توليه هذا المنصب المعقد، في هذا التوقيت الحرج، يعرف أن التغيير القادم يحمل طابعاً ثورياً، واللغة القادمة هي لغة عمل، ونتائج، ومحاسبة، وليست لغة التطمينات الخطابية المعدة للاستهلاك اليومي. فلعل وعسى، ونحن في الانتظار.أعود إلى مكتب معاليه، والأوراق المكدسة عليه، من تقارير، وخطط، واستراتيجيات، وتوصيات، وغيرها، لا بد أن ما فيها دقيق، وبنّاء، وجاد، إلا أني أعتقد أن من الأوراق المفيدة، وأكثرها استحقاقاً للمكث مدة أطول فوق مكتب الدكتور عبدالله، وبين يديه، ونصب قراراته، هي يوميات الطالب الجامعي، بحكم أن الطالب (كما يُفترض) أساس العملية برمتها، وبما أن هذا النوع من التقارير (الفنتازية) غير موجود، فهذه إذن محاولة لاستقراء كل ذلك، ودمجه في مقال مختصر (مختصر قدر المستطاع، وفق ما تسمح به نظرية الشق والرقعة الشهيرة)، وهو يصف الحالة العامة لطالب في جامعة الملك سعود، بدأ مستجداً، وانتهى وهو مستجد، لأن المعضلة الجامعية كانت أكبر من فهمه، والمتاهة الأكاديمية التي حط بها أخيراً أفقدته الصواب والخطأ معاً، فانتهى أخيراً إلى ما انتهى إليه غيره، وسلم زمام أمره لممرات الجامعة، تسيره كما تشاء أمزجة الأكاديميين الكبار، فمنذ بداية دخوله الجامعة يشعر الطالب أن للممرات عليه سلطة ما، وعليه أن يحترمها وهو يطأ عليها ما دامت خطاه ستعقد صداقةً معها لأعوام مديدة، سواءً وهو (يسافر) من قاعة إلى قاعة ليلحق بمحاضرة، أو (ينغرز) مثل وتد منسي أمام مكتب دكتور لا يعترف بساعاته المكتبية، أو يصطف في صفوف المنقطعين والغارمين لاستلام مكافأة، أو تسجيل مادة، أو شراء وجبة! ورغم ذلك، تظل علاقته بالممرات أجمل بكثير من غيرها، فممرات جامعة الملك سعود، على الأقل، أقل تعقيداً من قوانينها، لاسيما تلك غير المكتوبة، والتي يطلقها في الهواء كل دكتور أو محاضر أو معيد حسب مزاجه اليومي أو الفصلي أو السنوي أو الأبدي! ويستقبلها الطلاب مثلما يستقبل الراديو موجات الإرسال، فيمتثل لها كما هي، دون أن يكون له الخيرة في تغيير حرف منها، مما يعمق لديهم الشعور التدريجي (الذي يتحول عند التخرج إلى مسلّمة!) بأنهم إنما انتقلوا من مدرسة أصغر، إلى مدرسة أكبر، مع الاحتفاظ بميزة الرعاية والاهتمام الشخصيين للمدرسة الأصغر طبعاً، مقارنة بهذه الغابة الأكاديمية. هذا الطالب تعرف أثناء حياته الجامعية الدرامية على المسجل (أ) والدكتور (ب) والمحاضر (ج)، والمعيد (د). وهو بحاجة أن يسرد قصصهم جميعاً، فكلهم ساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل الخارطة النفسية للطالب، وغير مسارات حياته الجامعية، وعكس توقعاته، وخربش على جدار أحلامه، وعلمه كيف تؤخذ الدنيا (غلابا)!
وحالما يُقبل الطالب في الجامعة، ويبدأ يومه الأول، يستلم جدول المواد المفروضة عليه فرضاً، مثلما يستلم الجندي ملابسه وبسطاره، دون أن يختار منها مادة واحدة، وهذا التسجيل الإجباري هو ميزة أكاديمية تنفرد بها جامعة الملك سعود دون كل جامعات العالم (ما عدا الجامعات المتميزة أيضاً هي الأخرى) فلله درها، ويبرر المسؤولون ذلك بأنه عند تطبيق النظام السابق، التسجيل الاختياري، أدى انخفاض وعي الطلاب إلى تأخر تخرجهم بشكل فاضح، وبالطبع فإن الطالب هو المسؤول عن كل مشاكل الجامعة، وهو العنصر السيئ الذي ينبغي استئصاله من الجامعة حتى يصلح حالها، ويعتدل أمرها. فبما أن كل طلاب الجامعة لا يحملون وعياً كافياً بالتسجيل الاختياري، قررت إدارة الجامعة حرمانهم منه حرماناً جماعياً، وعن بكرة أبيهم، تخفيفاً للصداع الإداري الذي تسببه إجراءات التسجيل، والتكدس الطلابي الذي يسببه تأخر التخرج، وهذا قمة العدل، لأن أعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي الجامعة بريئون تماماً من بيرواقراطية إجراءات التسجيل، وتأخر التخرج، وكل المشاكل من هذا الطالب، قليل الوعي!
ورغم ذلك، يسعى الطالب المستجد أن يجرب حظه للمرة الأولى، ويحاول مثلاً، يحاول، أن يغير إحدى المواد، فيذهب إلى مسجل الكلية الذي ينتمي لدولة عربية مجاورة، ولا يدري أية كفاءة هائلة يتطلبها هذا المنصب حتى إنه لا يوجد سعودي يشغله! فيفاجأ بكومة من الطلاب أمام المكتب الصغير، يتدافعون بشكل يكاد يخيفه، ويدفعه للعودة من حيث أتى، إلا أنه يشد من عزيمته، ويردد في نفسه (هذا هو التحدي الأكاديمي الأول لي!)، فيتدافع مع المتدافعين، ويتزاحم مع المتزاحمين، حتى إذا وصل أخيراً إلى حافة مكتب المسجل، لاهثاً متعباً، وقدم له جدوله الذي تكرمش من شدة التدافع، وطلب تغيير المادة بكل أدب، صاح في وجهه المسجّل العربي ((لا، ممنوع، امش من هنا!))، فيجيبه بانكسار ((ولكني لا أرغب بدراسة هذه المادة في هذا الفصل؟))، فيرد عليه المسجل بصوت أعلى ((مش على كيفك! النزام كده!))، فيقرر أن يترك المكتب، يائساً، ومرتبكاً، ولكنه أثناء خروجه، يتناهي إلى سمعه المسجل وهو يتحدث في الهاتف عن طالب آخر: ((الطالب ده لازم نسجل له المادة دي، دا ابن عميد كلية ال.....!)).
هذا هو المسجل (أ)، النزيه جداً، النظامي المحترف، ذو الكفاءة المهنية التي عجز عن إنجاب مثلها كل هذا الوطن، بمعدل بطالته الذي وصل إلى تسعة بالمئة من ذكور الشعب، فضلاً عن إناثهم، والذي، من فرط ثقته بنفسه و(ظهره)، ومهنيته العالية، لا يتورع أن يصدع بكلمة (الواسطة) تلك، في حضرة عشرات الطلاب الواقفين أمامه، وهو المناطة به أمور تسجيلهم ودراستهم، فإذا به يمنح نفسه حق العطاء والمنع، والتفضل والحرمان، بل و(تسعود) جداً حتى أصبح يمارس (الواسطة) علناً، على طريقة مواطنه التاريخي فرعون عندما سألوه: من فرعنك؟ فأجاب إجابته الشهيرة. هذا المسجل اللطيف سيظل يتعامل مع صاحبنا الطالب في بداية كل فصل دراسي طيلة السنوات الأربع أو الخمس القادمة، وهو ينفرد بفضل أنه قدم للطالب المستجد أول خيباته الجامعية في هذا (الحرم) الجامعي الذي يُفترض ألا تنتهك فيه الأخلاق، ولا ينكسر فيه النظام.
وهكذا يطوي الطالب جدوله، ويقنع نفسه أن واضعي الجدول هم أدرى بمصلحته، ولعلهم يرون ما لا يراه، والله المستعان. حتى إذا ولج القاعة، راح ينتظر بترقب كبير أن يرى ذلك الكائن الأسطوري المنتظر (الدكتور)، مستحضراً في ذاكرته الشعبية كل الحكايات التي سمعها من أخيه الأكبر، أو صديقه في الاستراحة، أو جاره الذي يمشي معه إلى المسجد، أو غيرهم، عن (دكاترة) الجامعة، وكيف أنهم (بشرٌ) غير أولئك المدرسين الذين تعود عليهم في الثانوية، فهؤلاء لا سلطة لمدير عليهم، ولا يخيفهم المرشد الطلابي، ولا ولي أمر الطالب، فإذا قضوا أمراً فلا رادّ له إلا قضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا حكموا على طالب ما بالرسوب، فلا ينقض حكمهم لا استئناف، ولا رئيس القسم، ولا ديوان المظالم، ولا النظام القضائي بأسره، وإذا عنّ لطالب أن يشتكي فلقد حكم على نفسه بالموت الأكاديمي في بركة البيروقراطية الموحلة التي لا تستنكف أن تحيل الخصم، حكماً، في وجه الطالب المسكين!
أثناء انتظار الطالب للدكتور في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود، يتذكر تلك الأسطورة القديمة والشهيرة التي سمعها من أخيه الأكبر الذي تخرج من نفس الجامعة قبل عدة سنوات، عن ذلك الدكتور الذي قال لطلابه في أول محاضرة ((ممتاز ما يقدر عليها إلا الله، والجيد جداً ما يقدر عليها إلا أنا، والجيد ياخذها الشاطر منكم، والبقية كلهم مقبول أو رسوب!))، ولا يدري الطلاب إلى أي نظرية تحفيزية تنتمي هذه العبارة الأوتوقراطية في علوم التربية والأكاديميا؟ ولكنها تظل أسطورة شهيرة على أي حال، وربما لا تكون واقعية، هكذا يحاول الطالب أن يشجع نفسه، رغم أنه بمرور الفصول الدراسية، يكتشف فعلاً أن درجة (الممتاز) صعبة المنال، ولا ينالها إلا أقل من 10% من الشعبة بأسرها، فيندهش، لأن زميله الذي تخرج معه من الثانوية بمعدل أقل من معدله، وسافر إلى أمريكا ليدرس في جامعة أفضل في التصنيف العالمي من جامعة الملك سعود، (بل وتبتعث جامعة الملك سعود طلابها لتحصيل الدكتوراه منها)، يتصل معه عبر الإنترنت يومياً، وهو يحصل على (الممتاز) في أغلب مواده حتى الآن، وبما أنهما يدرسان نفس التخصص، فإنه من الغريب أن تكون (الممتاز) الأمريكية سهلة المنال نسبياً، ويحصل عليها أكثر من 50% من الطلاب، بينما (الممتاز) السعودية عزيزة، متمنعة، صعبة المنال، ولها (خصوصية) تتيح لها أن تكون كذلك!
يقلب الطالب في عقله المرتبك كل هذه الأفكار المتناقضة، وهو يطالع سجله الأكاديمي المتهالك، بعد أن صارت الـ 95% التي أحرزها في الثانوية شيئاً من النوستالجيا المؤلمة! ترى لماذا يصعب عليّ أن أحصل على الممتاز في جامعة الملك سعود، بينما صديقي الذي كان أقل مني مستوى، يحرزها بسهولة في أمريكا، وفي جامعة متفوقة في التصنيف الأكاديمي على جامعة الملك سعود؟ علماً بأنه، حسبما يحكيه لي عبر الإنترنت، لا يكاد يدرس! لماذا (الدكاترة) في السعودية يصرون على أن يجعلوا الأخ (مقبول) الحليف الجامعي الحتمي لأغلب الطلاب؟ رغم أن هؤلاء الدكاترة أنفسهم، تخرجوا من أمريكا، وشديدو الاعتداد بشهاداتهم الأمريكية الأنيقة، فما الذي يمنعهم أن (يقتدوا) بدكاترتهم الأمريكان السابقين في منح (الممتاز) بسهولة يا ترى؟
ثمة لغز هنا! وهو لا يشغله وحده، بل يشغل الآلاف من الطلاب المصابين بلعنة (المقبول) و (الجيد)، فيطلقون أسئلتهم في كل الاتجاهات الممكنة، مثلاً باتجاه: دكتور متعاون، يجيب على أسئلة الطلاب بنزاهة، أو رئيس قسم سابق، قرر أن يكشف المستور. والإجابة الشائعة التي لم يؤكدها أحدٌ بعد، أن نسبة النجاح في كل شعبة يتم تحديدها سلفاً، ولأسباب غير معروفة، ولكن الإشاعات تقول إن مرد ذلك هو منع تكدس الطلاب في المواد المتقدمة، أو تقنين نسبة الخريجين لتتوافق مع قدرة سوق العمل على الاستيعاب! وهذه الأخيرة لا بد أنها توجيهات عليا، لا يمكن خرقها، مهما كان الضمير الأكاديمي لدى الدكتور يقظاً، ومتمرداً، فثمة رئيس قسم، وكيل كلية، أو عميد ما سيراجع درجات الطلاب قبل اعتمادها. وبغض النظر عن صحة التبريرات، والتعليلات، والإشاعات، فالمشكلة قائمة، وغريبة فعلاً، أن يكون أغلب خريجي الجامعة الأكبر في السعودية من أصحاب المقبول والجيد، لابد أن السبب أيضاً هو (قلة وعي) الطلاب!
نعود لصاحبنا الطالب، بعد أن مرت عليه ثلاث سنوات من الدراسة في الجامعة، جاء اليوم الذي صدقت فيه الأسطورة الشهيرة. كان الطالب يجلس في منتصف مدرج هائل في كليته، يغص بمئة وعشرين طالباً، ورغم أن المادة ليست من المتطلبات الأساسية في الكلية، إلا أنها مزدحمة بالطلاب من فرط الرسوب، والتراكم، ثم الرسوب، فالتراكم. ولا يدرّسها إلا دكتور واحد، من الإخوة العرب الذين تتفوق فرنسيتهم على عربيتهم بكثير، وهو (يحتكر) تدريس المادة، كما يحتكر اللوفر لوحة الموناليزا، مع الفارق الجمالي الواسع. هذا هو الدكتور (ب)، الذي دخل دخول الفاتحين، وجلس على الكرسي، وراح يتأمل المدرج الهائل المليء بضحاياه السابقين، وضحاياه اللاحقين، وبعد صمت ثقيل استمر لخمس دقائق، لا يكاد فيه الطلاب ينبسون ببنت شفة، تكلم الدكتور بصوت هادئ: ((أنا، لمن لا يعرف اسمي منكم، اسمي (...)، وهذه المادة هي (...)، والممتاز لا يقدر عليه إلا الله، والجيد جداً لي أنا، وباقي الدرجات لكم!))
يا إلهي! الأسطورة تتحقق! وفي المدرج الكبير، سرت رعدة جماعية شملت جميع الطلاب، وراح كل منهم يفكر في شكل سجله الأكاديمي بعد هذه المادة، وهو مثقوب بالرسوب، أو المقبول، بتوقيع هذا الدكتور. ولوهلة، فكر صاحبنا الطالب أنه أخيراً فهم سبب التشابه اللفظي بين (الدكتور) و(الدكتاتور)، وكم للّغة من أسرار! ولكنه احتفظ باكتشافه الشخصي لنفسه، بينما ساد الوجوم في الوجوه والعيون، وسرت همهمات غير بريئة، في الصفوف الخلفية. كان المشهد في المدرج محزناً، إلا أنه يصلح ليكون أبلغ رد على كل من يتهم السعودية باضطهاد الجاليات العربية، أو التقليل من شأنها، فليأتِ لينظر ما يفعله هذا الدكتور العربي الرائع، في أكثر من مئة وأربعين طالباً سعودياً، كلهم يؤمن بالله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره!
منذ بداية المادة، عرف صاحبنا الطالب الذي صار خبيراً في موازين القوى الأكاديمية بعد ثلاث سنوات في الكلية، أن هذا الدكتور لا قبل له بمواجهته، وأن فرصته الوحيدة للنجاة من هذه المادة التي يحتكرها الدكتور منذ أبد الآبدين هو الدعاء بأن ينجح فيها بهفوة إحصائية من علم الاحتمالات. وهرع فور فراغ المحاضرة الأولى ليبحث عن مدرس خصوصي من بين المعيدين والمحاضرين الموجودين في القسم، وبالطبع، لزيادة فرصه في النجاح، يجب أن يكون هذا (المحاضِر) الخصوصي من نفس جنسية الدكتور، وهذا ما فعله، وبالتالي تعرف أخيراً على المحاضر (ج)، والذي تفاوض معه على تسعيرة الدروس الخصوصية الثابتة في السوق السوداء للكلية وهي خمسة آلاف ريال للطالب وحده، وسبعة آلاف للطالبين، وتسعة آلاف لثلاثة طلاب، واختار صاحبنا أن يدرس وحده، لعل ذلك يجعل شفاعة المحاضر عند الدكتور أسهل، واستدان الآلاف الخمسة من بعض أقاربه، واعداً إياهم أن يردها لهم بعد التخرج!
بدأت الدروس الخصوصية، وبدأ هذا الطالب في الاستذكار بشكل استثنائي، حارصاً ألا تفوته شاردة ولا واردة ينطق بها الدكتور في المحاضرة إلا سجلها في مذكرته بأربعة ألوان، وحارصاً بشكل أكبر على إكرام المحاضر الذي يأتيه في البيت أيما إكرام، فلا يكاد المحاضر (يقلط) حتى تكون القهوة والشاي والمعجنات في انتظاره، وربما تأخر عليه قليلاً فاستغل الفرصة ليطلب منه البقاء للعشاء، لعله يتذكره في يوم الشفاعات، رغم أن المحاضر كان واضحاً معه من أول درس بأنه لا يملك للطلاب نجاحاً ولا رسوباً، وأن الدكتور (ب) صارم جداً في تصحيحه، وملتزمٌ جداً بنسبة النجاح التي يحددها له رئيس القسم، إلى حد أنه عندما يبدأ في تصحيح أوراق الطلاب المئة والعشرين، واحدة تلو الأخرى، ثم يجد في منتصف تصحيحه أن الناجحين منهم وصلوا للنسبة المحددة، أخذ بقية الأوراق غير المصححة، دون أن ينظر إليها، وسجلها رسوباً. فضحك الطالب من نكتة المحاضر هذه، واعتبرها من (لهو الحديث)، ورفض تصديقها، بينما زمّ المحاضر شفتيه، وهزّ رأسه باستخفاف، وراح يكمل الشرح.
نجح الطالب في المادة، وتحققت الشفاعة. وكانت درجة (الجيد) التي أحرزها تستحق الاحتفال بعد أن تجاوزت نسبة الرسوب في الشعبة الأربعين في المئة، كما يثبت ذلك الأرشيف السري للقسم بالطبع، وكانت درجات الطلاب تعكس دقة عبارة الدكتور التي بدأ بها الفصل، ومصداقاً لما أسماه بإنجليزيته ذات اللكنة الفرنسية (integrity).
المعيد (د) هو طالب حديث التخرج، يمارس الإعادة في القسم في انتظار إجراءات ابتعاثه، وعندما ولج صاحبنا الطالب إلى محاضراته كان مستبشراً بأنه مقبل على التعامل مع طالب مثله، يشعر بما يشعر به، ويقتسم معه الهموم والظنون. ولكن يبدو أن سلسلة التوقعات الخائبة منذ التحاقه بالجامعة ما زالت مستمرة، فهذا المعيد الشاب لم يكن إلا (ابن الحجاج)، ولقد بدأ محاضرته بطريقة عجائبية في فرد عضلاته الأكاديمية، هو الذي تفصله أشهر قليلة فقط بين هذا الكرسي، وتلك السبورة. فبعد مقدمة بسيطة، راح يتلو على الطلاب قوانينه الشخصية. وكان أولها: ((يمنع منعاً باتاً على الطلاب أثناء المحاضرة.. الإمساك بالقلم!))، ولم يفهم الطلاب ما هو العائد التعليمي من هذا القانون، فاستزادوه توضيحاً وهم ما يزالون يعتقدون أنه مقرب منهم بصفته حديث التخرج، فقال لهم: ((هذا هو نظام محاضرتي، اعتبروا أنكم في خطبة جمعة، ومن مسّ الحصى فقد لغى!))
يحرم المعيد (د) على الطلاب نقل ما يكتبه على السبورة من الشرح إلى دفاترهم، ولا حتى تدوين الملاحظات العابرة، ولاشك أن هذه ثورة في نظم التعليم الحديث، لم يسمع بها الطلاب من قبل. ولما كان القانون عجائبياً فعلاً، قام بعضهم بمخالفته من باب (الحرية الشخصية)، ومنهم صاحبنا الطالب الذي أخرج قلمه، وراح يدون ملاحظاته على الشرح في دفتره الشخصي، ففوجئ بالمعيد يشق صفوف الطلاب فجأة، ويتجه إليه مباشرة، ويأخذ دفتره، وينتزع الصفحة التي كتبها الطالب، ويرميها في سلة المهملات!
وبغض النظر عن كل الممارسات التعسفية التي يمكن أن ترتكب بحق أي طالب مغلوب على أمره في جامعة الملك سعود، فإن أغلبها لا يتجاوز السلطات الأكاديمية والإدارية، بينما ما فعله هذا المعيد (د)، كان اعتداءً شخصياً على الطالب، وتخريباً متعمداً لممتلكاته الشخصية، وإهانة مباشرة لكرامته. و هذا ما دفع صاحبنا الطالب لحمل أوراقه، والخروج من القاعة، حانقاً، وغاضباً، وهو يشعر بمرارة الإهانة، وأن سنوات عمره الاثنتين والعشرين لم تمنع من أن يتعامل معه من يكبره بسنوات قليلة بهذا الأسلوب المهين. بينما ساد الوجوم في القاعة التي تغصُّ بالطلاب الثلاثين، لم يكسره إلا صوت الباب الذي انغلق بعد خروج صاحبنا، بينما راح طلاب آخرون يعيدون دفاترهم إلى حقائبهم بهدوء.
ابتلع الطالب تلك الإهانة مقنعاً نفسه أنه لم يبق إلا سنة على التخرج، ولا داعي لخلق المشاكل، لا سيما تلك المشاكل التي لا طائل منها، فليس من المتوقع أن يؤنب رئيس القسم أو عميد الكلية معيداً متفوقاً، ودكتوراً محتملاً، من أجل طالب، ولو كان ذلك متوقعاً وممكناً لانعكس على سلوك المعيد أصلاً. واستمع الطالب إلى نصيحة أخيه الأكبر الذي تخرج في الجامعة قبله ((كلما كنت مجهولاً ومغموراً، تيسرت أمورك، وتخرجت سريعاً!))، وعاد صاحبنا الطالب إلى محاضرة المعيد، مكتفياً بالسواك هذه المرة بدلاً من القلم، ومعتمداً على ذاكرته فقط في تذكر كل الملاحظات التي يمكن أن يستنبطها من الشرح.
الغريب المريب، والذي يثبت فعلياً أن لكل عضو هيئة تدريس (دستوره) الشخصي في تسيير المادة، أنه في مادة أخرى، كان المعيد من جنسية عربية ينتقد أحد الطلاب لأنه لا يقوم بتدوين الملاحظات، وصدح بقانونه المسجوع ((كل علم لم يحفظ في القرطاس ضاع، وكل سر تجاوز اثنين شاع!)). ومن الطبيعي أن يكون لكل عضو هيئة تدريس قوانين صغيرة يسيّر بها محاضرته، ويعتمد عليها أسلوبه في التعليم، ولكن بعض القوانين تتضخم بشكل سرطاني، وتتحول إلى أحكام قطعية، تعسفية، ومشخصنة جداً، تفقد معها مردودها التعليمي المرجو (إذا افترضنا أن لها مردوداً إيجابياً أصلاً)، وتتحول في النهاية إلى مجرد أساليب سلوكية تهدف إلى بناء هرم من الهيبة الوهمية، تيسّر على الدكتور عمله، وتجعله أكثر رضا عن نفسه.
تخرج الطالب في الجامعة، وبحث عن وظيفة فور تخرجه، لعل أجواء العمل تعيد تأهيله نفسياً، وتركيب شخصيته المبعثرة، بعد تجربته الجامعية المريرة، والتقى بزميله في الثانوية الذي تخرج من أمريكا في نفس التخصص، (وبالطبع حصل على وظيفة قبله بأشهر طويلة!)، وراحا يتسامران ويتذكران أيام الثانوي المشتركة، ثم أيام الجامعة المختلفة. وقتها لم يفهم صاحبنا الطالب أبداً معنى أن يقول له زميله ((ياااه.. فعلاً.. سنوات الجامعة هي أجمل السنوات في عمر الإنسان!))، هل حقاً أن زميله جاد فيما يقول، أو أنه يهذي فقط؟ هل من المعقول أن (أجمل سنوات العمر) قد فاتته دون أن ينتبه لها؟ هل يعقل أن تكون أجمل سنوات عمره هي تلك التي قضاها في جامعة الملك سعود؟
معالي الدكتور عبدالله العثمان:
ما زال المسجل (أ)، والدكتور (ب)، والمحاضر (ج)، والمعيد (د)، ونماذج أخرى شبيهة، يعملون في جامعة الملك سعود بنفس الوتيرة، متسببين معاً في تشويه التجربة الجامعية للآلاف من الطلاب، وإلحاق الضرر النفسي والأكاديمي بعماد الوطن، فضلاً عن (تفويت) أجمل سنوات العمر! هذا الاتهام المباشر ليس عاطفياً أو درامياً كما يبدو، بل هو اتهام شرعي لا يطالب بأكثر من الحقوق الأساسية لصاحبنا الطالب، حسب تجربته الجامعية، وربما إن تجارب طلاب آخرين تفترض مطالب أخرى، (ودعنا لا نتكلم عن الطالبات حتى لا ينفرط المقال إلى عدة صفحات أخرى!)، ولكن صاحبنا يكتفي بالمطالبة بأشياء تبدو بدهية، مثل العدالة الإدراية في التسجيل، وإنشاء نظام محكم يضمن تطبيق النظام على الجميع، وهذا يبدو اقتراحاً حالماً في الجامعة التي ما زالت تكافح من أجل عدالة (القبول) فضلاً عن عدالة (التسجيل)، فلو تمكنّا، جدلاً، من الوصول إلى جهاز الحاسب المركزي، وطلبنا تقريراً عن طلاب الجامعة الذين تخرجوا في السنوات العشرين الماضية، مع معدلات الثانوي لكل منهم، لرأينا أرقاماً عجيبة! ليس لها أية علاقة بمتطلبات القبول في الجامعة! ولكن نسأل الله أن تبقى هذه المعلومات حبيسة الأرشيف حفاظاً على ماء وجه مسؤولي القبول، فصاحبنا لا يطالب بهذه الأشياء المستحيلة عموماً لفرط واقعيته، بل يطالب بالممكن المعقول وما يتم تطبيقه فعلياً في كل جامعات الأرض، مثل أن تتاح للطلاب حرية اختيار المواد التي تناسب استعدادهم الذهني للدراسة في هذا الفصل أو ذاك. ويطالب أيضاً بالعدالة الأكاديمية في التقييم والدرجات، وإنشاء نظام أكثر مرونة يكفل للطالب حق الاعتراض على تقييم الدكتور له، بل وتقييم الطالب للدكتور نفسه تقييماً يؤخذ في الاعتبار بجدية عند اتخاذ قرارات ترقية الدكاترة، وعلاواتهم، ومن المعروف أن هذا صعب، لكون الجامعة جهازاً حكومياً، يرضخ لاعتبارات بيروقراطية معقدة، وكون أعضاء هيئة التدريس موظفين حكوميين، مما يجعل التدخل في آلية ترقياتهم وعلاواتهم ليس بالأمر السهل، ولكنها ضرورة ملحة في النهاية، وإحداث التوازن القانوني بين الطالب والدكتور هو المفتاح الأساس لعلاقة أكاديمية إيجابية.
ربما راح المقال يخرج عن مساره المفترض، ليتحول إلى سلسلة مطالب لا أتوقع أن مكتب الدكتور عبدالله العثمان ينقصه المزيد منها، وعلى أي حال، الثقة موجودة في أن القادم سيكون أفضل، والتغيير المرتقب قريب. المطالب كثيرة يا دكتور عبدالله العثمان، والمسؤولية التي بين يديك ليست سهلة. والوطن يراقب، و(الوطن) أيضاً.
المصدر
جريدة الوطن السعودية، 19 يوليو 2007
جريدة الوطن السعودية، 26 يوليو 2007
جريدة الوطن السعودية، 2 أغسطس 2007